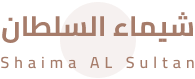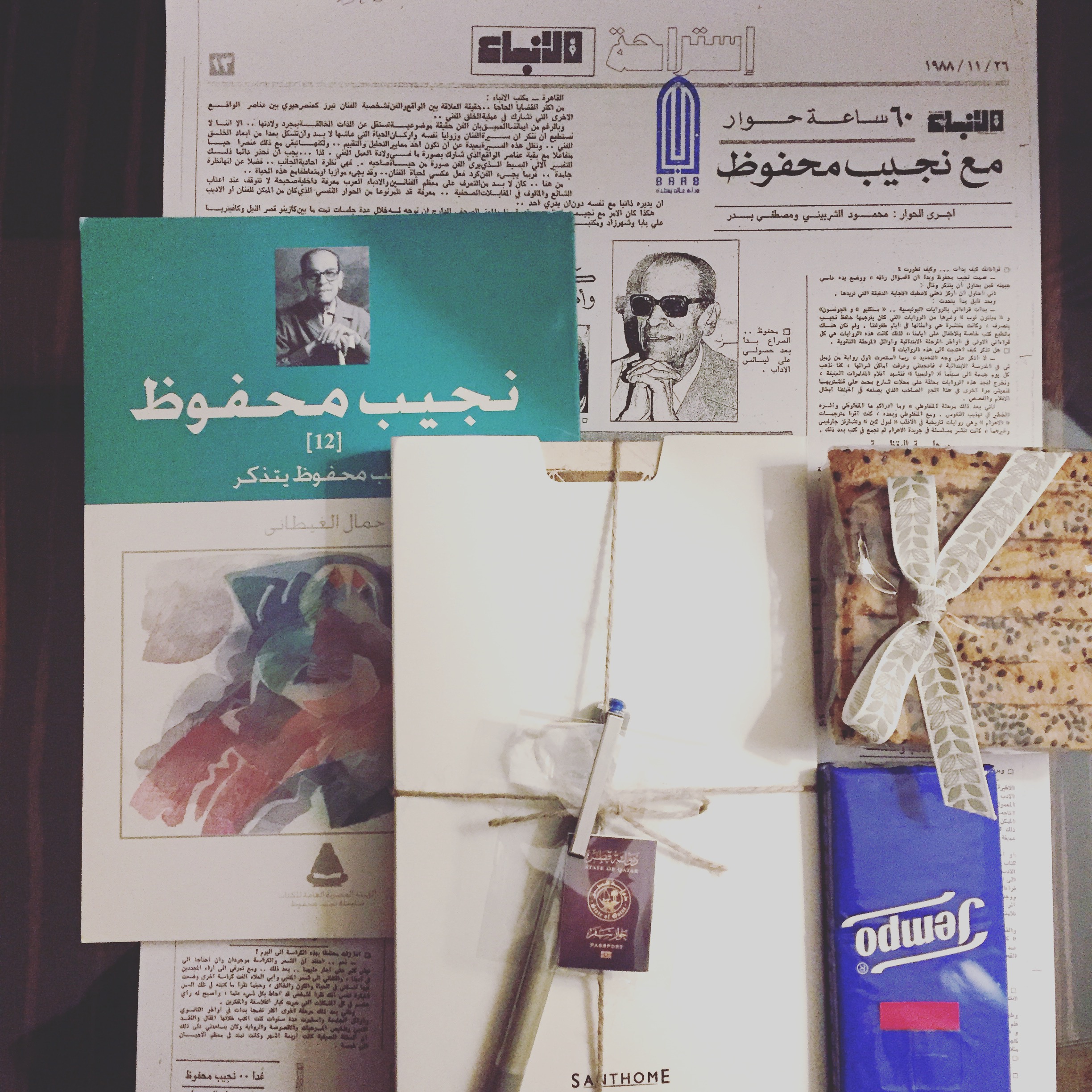اليوم بعد العاشرة
القصة القصيرة الفائزة بمسابقة فودا فون الأدبية*
قلتِ لي من ضعف:”بينما كنت تصرُ على الحياة هُناك، كنتُ أموت أنا هنا ألف مرة”. هذا ما قلته بعدَ سكوتٍ طويل بيننا. أذكرُ أن بشرتي كانت داكنة كَليل. هناكَ جراحٌ لم تندمل بعد. هناك وجعٌ ولكنهُ يذهب إلى الجحيم حينَ أراك. أعني. بعينيّ قلبي أبصرك.
كنا قد جلسنّا نلمع البسطار* سويًا. العادة التي باتت تعطينا فاصلاً مغايرًا للحياة التي لا تتوقف حولنا. أتذكر تلك الأيام بتفاصيلها. تمتلئُ شفتيك ضحكًا. وتصبحين أجمل. تبدو تفاصيل أيام العسكرية لكِ نُكاتًا وكانت تبدو لي وقتها قِطعًا من التعذيب. حين أسترجعها معكِ تبدو حُلمًا ابتدأَ مُرًا وانتهى بفرحٍ مباغت. قلتُ لكِ: أني تكاسلتُ يومًا ولم ألّمع بسطاري كما يجب، وحين جاء وقت التفتيش الصباحي أمرنَا الضابط بالوقوف تحت شمس الله الحامية في ظهيرةِ أغسطس لساعتين متواصلتين وبالطبع دون حراك أو همس ثم حجزنا حتى صباح اليوم التالي. وفي هذه الليلة تعرفتُ على سُعار (النيكوتين). مرر لنا أحد الزملاء عددًا من السجائر ولمّا كُنا في سأم تناولت أول سيجارة في حياتي وكان لها طعمُ التأفف من الحياة.
في اليوم التالي، استقيظتُ والدُنيا غارقةٌ في الليل. العصافيرُ لم تبدأ سعيها. وبين كل ذلك الهدوءِ استيقظتِ متململةٍ من الآلام التي تعبر جسدك. يجتاحني حنان حينَ أراك متعبة على هذا النحو. وضعتُ يديّ على بطنك الصغير، أتحسسُ نمو الجنين قلتِ: “أن ما يجلب السعادة أحيانًا، شقاءٌ طويل”. تفاصيل حديثنا صباحًا لم تفارقني، وسؤال أوحدٌ يمر أمامي: كيف سأخبرك عن الشقاء الذي سأتحمله، عن الشقاء الذي ستتحملينه، إن كنتِ ستفعلين. آلاف الصور تجوب في مخيلتي. أعرفُ ما أنا مقبلٌ عليه ولكنكِ لن تدركيه حتى تريني أمامك.
أتذكر وجهَ أمي حينَ أخبرتها أنني قررتُ الالتحاق بالكلية العسكرية. كانت تأملُ أن أتراجع. وكل ما قالته بحزنٍ طفيفٍ مُلاحظ: “الله يستر عليك”. تتذكرني عندما كنتُ صبيًا، هوايتي المفضلة شراء المسدسات. بكل أحجامها، بكل أشكالها. الرخيصة والثمينة. كنتُ أجمعها وأصفّها يوميًا قبل أن أنام بجانب سريري على الأرض. وجودها بجانبي كان يعطيني شعورًا بالطمأنينة. الأشياء التي نحبها أمانٌ من حيث لا نعلم. أختار لكل يومٍ مسدسًا مختلفًا. يومًا، مسدسًا مائيًا. ويومًا ذلك الذي يحدث دويًا ويومًا ذلك الذي يطلق الماء بدرجات متفاوتةٍ من القوة. يعرف أهل البيت أني صحوتُ من ركضي المتواصل في أنحاء المنزل. أتخيل دائمًا مداهمة على غرار الأفلام التي كنتِ أراها خلسة. يقتحم رجال الشرطة، يتقدمُ أحدهم مختبئًا وراء الباب الداخلي لإحدى الغرف، يعدُ لأقرانه بأصابعه، اصبع، اصبعان، ثلاثة، يركل الباب برجله بكل ما أوتيَ من قوة ودون أن يختل توازنه ويصوّب مسدسهُ نحو المجرم الذي اختبأ خلف الطاولة المقلوبة. تدور المناورةُ بينهما، يصوب على كتفه، يسقطُ الآخر، يدخل بقية الرجال، يقيدونه ويحملونه إلى السيارة المربعة. كنتُ أميّز بين جميع الحركات، أقلدها بشكل متقن. أغتنمُ كل الجمعات العائلية في بيتنا أو بيت جدي لأوزع المسدسات على أبناء وبنات عمومتي، نلعب سويًا ألعابًا مختلفة. تدور كلها حول جرائم نؤلفها، من أشياء نسمعها ونراها. تزيدها مخيلتنا الفتيّة شقاوة. كانت أمي تحبُ حماسي، ولكنها كانت تتحوّف منه أحيانًا. في مراهقتي لم تفارقني خيالاتُ الطفولة، فقررت الاشتراك في نادي الرماية. كانت نظرتي حادة، اعتدتُ التصويب. بدا الأمرُ مثاليًا ومناسبًا والأكثر أني أحبه. في الأيام الأولى كنتُ أختبرُ حمل المسدسات والرشاشات بأوزانها الحقيقية وملمسها المصقول، الدقيقِ والبارد، يدايّ وحدهما ما تمنحهم الدفء. أتعرف على (الماغنوم) وفاصئل (البارييت)* على الأسماء الدقيقة للطلقات ونوعية الأسلحة. كنتُ مغرمًا. أعود من التمارين منتشيًا. لا أخبرُ أمي عن أسباب الأدرينالين المتدفق في أوصالي. تدركُ ما لا أقوله بحدسها الواعِ. الكلية العسكرية تمثلني. كنتُ دومًا قويّ البنية، وكان طبيعيًا أن أصبح قناصًا. كان ذلك فأل عيني وصنيعةُ الله فوقهما. لم تعارض أمّي. والدي كانَ مُحايدًا، لم يكن حساسًا يومًا ولم يكن قاسيًا. كان والدًا. قال لي: “رجل يا ولدي”. وضرب على صدري بقوة. كانت مشاعري تجاهه أبدًا منضبطة. أعود بذكرياتي معه، تجيء في بالي ذكرى التخرج كانت نظراته مشبعةً بالحنان والفخر. وقف عندما سمعَ اسمي من ضمن المتفوقين كأنه يقول للعالم: “هذا هو ابني. “. أراه من بعيد وأبتسم. لم أستطع الانجراف عاطفيًا حين انتهت مراسم التخرج، أقبلتُ لأسلم عليه وأقبل يده. ضمنّي إليه بحرارة وقال لي هامسًا: “فخور بك وستفخر بك قطر يومًا”.
حينَ جمعنا قائدُ الأركان في هذا اليوم بعد العاشرة صباحًا ليخبرنا بأننا سنغادر بعد أيام قليلة للحدود الجنوبية. لم يكن الأمرُ مفاجئًا. فالكل كانَ متأهبًا والكل كان مُتكتمًا حتى لا تنفلتَ منه نصَال التوتر. لم يكن وقع الأمر هينًا. ففكرة التوغل في حدودٍ لبلاد لم نطأها يومًا ليست باليسيرة. هناك ما يتعلقُ بالطبيعة الجغرافية، وهناك ما يتعلق بالامدادات والترتيبات. وهناك ما يتعلق بالعدو الذي يعرف الأرض. كل الأمور مدعاةٌ للقلق ولكنه قلقٌ يزول. القلقُ الحقيقي هو شأنكِ أنتِ يا علياء. كيف لي أن أخبرك دون أن أتخيل أسوأ ما يمكن أن يحدث لي ولك. وأسوأ ما يمكن أن يحدث للطفل القادم إلى الحياة في اللحظة الحرجة سياسيًا.
دخلت المنزل، حاملاً معي صخبًا مدويًا في أعماقي. أمّي، تنظرُ إليّ. أقبلُ رأسها ويدها أسألها عن أخبارها. ترد: “الله يستر عليك”. منذ زمنٍ لم أضع رأسي على حجرها. حينَ قالت لي: “الله يستر عليك” توجعت. كانت تحس بي. ظلت صامتة تمسحُ على رأسي الحليق. تردد أذكارًا. كانت تصلي لي والدوي داخلي يزداد. كيف سأخبرها؟ قررتُ أن تكون هذه الدقائق عميقة لتنقش في ذاكرتي. أسحب يدها وأقبلها، أرفعُ عينيّ وأتشبعُ منها. أحاول اختزال أكبر قدرٍ من وجهها. تسقط نظراتها في عيني، سابقًا كنتُ أحيد بناظريّ عنها. هذه المرة كنتُ أريد أن أحتفظ بعينيها. بلونهما الباهت في الكِبر. برموشها التي تطبطب عليّ مع كل رفةِ جفن. كنت أريد أن أحفظ تجاعيد وجهها النيّر وكل خطٍ رفيع في وجهها الذي يقصُّ حكاياتي. أنا طفلها الوحيدُ ذو الشقاوّة المحببة سيغادرُ للحرب والله وحده يدري كيف سيعود؛ إن كان سيعود أصلاً.
نزلتِ يا علياء بخطواتك الخفيفة على الدرج. قلت في نفسي: سأخبرهما سويًا بالأمر. ستشد كلٌ منهما عزم الأخرى. وهكذا لم يكن هناك متسع لتغرق أيٌّ منكما في مخاوفِها أمامي حتى حين. قُلت الخبر ببساطة. بالكثير من التبسّم والتفاؤل كما نفعلُ تمامًا في المعسكرات التحضيرية نقتلُ الجدية والقلق بالكثير من التهكم. طمأنتكما إلى وضعي كقناص وأكدتُ أنّي لن أكون معرضًا للخطر. وقلت كلامًا باردًا لم يرق لكما ولكن كان علي أن أملأ صمتكما حتى أتجاهل نظراتكما التي كانت تخترقُ جلدي وتجلدني. أطلتُ في الأكل لأتجنب مواجهتكما. ولكن، هل كان لي أن أفر؟
ارتيقنا السلالام في صمت وفور وصولنا تحول ارتباكك عويلاً ولم يكن بمقدوري وقفُ طوفانك. حادةً وتبعثرين الكلمات. سمعتُ من بين كلماتك وأسئلتك ما لم يكن بمقدوري الرد عليه: “أنانيّ”. “كان يمكنك أن ترفض”. “قل لهم أنا وحيدُ والديّ”. “ماذا تتوقع مني؟”. “متى تعود؟”. “لماذا تصمت؟”. وسيل من الأسئلة تنجرف مع بكائك. لم أستطع الرد. قمتُ إليكِ وضممتكِ إلى صدري. كنتِ رطبةَ جدًا وأنا نارٌ أكويك وأكتوي. وودت لو أقول شيئًا يردُ عنك حزنك ولم أجد سوى الصمت. وصمتُ الرجال بكاء مستتر. بدت القيلولة مستحيلة في ظل ذلك التوتر. أقوم وأتأكدُ أنك بجانبي. تفزعين من النوم وتتأكدين أنني هنا، شهيقك الذي يعلو من هذيانٍ يفيقني. أدركت حينها أن حلم الطمأنينة الأبدية قد ولّى.
من الأعلى في الطائرة العسكرية بدت التضاريس تنادي السلام. الفجيعةُ تغتال كل شيء. ألسنةُ اللهب والدخان الذي يتحلق ليشكل عزاءً كبيرًا. من يحضر عزاءات متكررة في بلدٍ يشبه الموت كل ساعة؟ من يحضرُ مراسمَ العويل على بيت تهدّم ولم يبقَ لأهله سقف؟ ومن يولول مع امرأة فقدت عشيرتها كلها؟ تمتدُ قوافل المساعدات البرية. طوابير من السيارات تخترق الجبال والطرقات العسرة لتقول للذين لا ذنب لهم في مسيرة الحرب: “إنّا هنا معكم”. نحاول أن نخفف وطئة الدمار ووحشية الأيام القادمة بالعطاء. نسير على “نهج الأُلى”، حمائم للمستضعفين جوارح على المعتدين. في الحرب، يتساوى الناس. الكل يبحث عن الخبز وكسرة الأمان ويبدو الخبرُ المفرح ترفًا. تجيء الصورُ التي تعرض في القنوات الاخبارية في بالي تلك التي تستخدم في الدعاية وليست تلك الحقيقية على أرض الواقع. تلك المشبعة بالألوان. الطفلُ ذو العيون الخضراء والبشرة الداكنة من التشمس الإجباري بشعره المنكوش وأظافره المتسخة وأسباله المهترئة. كل الألوان واضحة والحقيقة أن لون البؤس أسود ولو جملته دعايات فاتنة. هؤلاء الذين يتاجرون بأوجاعِ المتعبين، يقفون بكل وجلٍ أمام هؤلاء بكاميراتهم الثمينة ليبيعوا الصور في مزاد علنّي لمصائب الآخرين. مع هبوط الطائرة أحسستُ بأني الآن أودعكِ حقيقة. كنتُ على الباب وكان آخر بنانك يلامس طرف بناني كنتُ أهربُ من كل الحنين. كنت أقول للشوق ذرني. وأقول للذكريات كوني عزمي. لم تقوَ أمي على وداعي تماسك والدي على عادته إلا أن حشرجة صوته فضحته قال لي مربتًا على كتفي: “الأبطال يولدون في الأزمات”. ذكرته؛ أن يكون لطفلي الذي سيولد بعد أشهر والدًا. أوصيته أن يهمس في أذنه بعد أن يأذن فيها: “بابا منصور يحبك يا سالم”. رفع رأسه كأنه يسحب دمعته لأعلى وقال : “انتبه لنفسك وتذكر: هداتنا يفرح بها كل مغبون”. قلتُ له: “لا تقلق، قطرٌ ستبقى حرةً تسمو بروح الأوفياء”. خرجتِ معي وعند الباب ضممتكِ يا علياء إليّ كأني أغرسك في جسدي حتى أنكِ تألمتِ. ولأول مرةٍ وفي مكان غير المسموح لنا فيه بالقبل الطويلة، قبلتكِ غير آبه بالعالم. كنت أقول لكِ في داخلي: “سأعود”، لم أكترث بخجلكِ أو دموعك أو قبضتك المرتخية على أكتافي. كنتُ أريد أن أجمعكِ كلك فيّ. أصهركِ وأنصهر فيك حتى آخر قطرةٍ فيك وفيّ.
في الثكنة يكون الأمن مستتبًا، نلتقي بالرفاق من المعسكرات الأخرى للدول الشقيقة. نحاول رتق خيوط الأمل للغد الأفضل. نحاول جاهدين تذكر الأشياء الجميلة. اعتدنا على اللهجات المختلفة. هذا التنوّع يذكرنا بقوتنا. بوحدتنا وبالكثير من الأواصر التي تربطنا. ينشدُ الرفاق بعض الأغنيات الجنوبية، بتلك اللهجة الفريدة، وإن كنا لا نفهم الكثير منها فإننا نطرب لها ويغرق اللحن الرخيم في الليل ويغرقنا حتى لا نجد نجاة إلا في الرقيق المتبقي من ذاكرتنا. يغني عيد:
ما أنسى ليالـي سلا عشرة ورفقة سلا
مشتاق قلبي : ألا مشتاق قلبي : ألا
يا ظبي ميل خـلب مغـرور يرقص أدب
قفا ومني جلب مشـتاق قلبي : ألا
لا أحمر ولا زيديه صافي صفاء النـية
وامشمس مدنية مشـتاق قلبي : ألا*
“مشتاق قلبي ألا” نرددها معه وكل تشده ذكرياته في اتجاه. وأنا تشدنّي ذكرياتي إليك. أتذكر افتتاني القديم بك. كنتُ لكِ وكنتِ لي منذ أول يوم دافعتُ فيه عنكِ. قلتِ لك: “حينما أكون موجودًا لا تخافي من أحد. أنا عندي الأسحلة التي تحميك”. ابتسمت ودلفتِ إلى الداخل خجلة ودخلت قلبي ولم تبارحيه. الأيام قاسيةٌ دونك. كثيفة وحارقة. كوتنا الشمس وبدونا جميعًا أكبرَ سنًا. الوجع كفيل بزرع سنين مضاعفة في أعمارنا. كيف سترينني عندما أعود؟ ستحبينني؟ أسأل نفسي وأترك الاجابة في ترديدي. “مشتاق قلبي ألا”.
تمضي الشهور ثقيلة بين خطوط المواجهة وتكتيكات التوغل في الداخل والتنقل بين المواقع وعبور التضاريس الصلدة. ساعات المواجهة مع المقاتلين تطول وتقصر حسب ظرف المكان وعامل الجو. الكل متأهب ومستعد. يحدث أن نصاب بجراح طفيفة إثر اشتباكاتٍ متفرقة. ويحدث أن تمر أيامٌ هادئة لا ضرر فيها. نصاب بجراح تستنزفُ قوتنا إلا أنها تبرأ. أما الجراح التي تستنزفنا حقًا وتبقى عميقة كجُبّ، فهي التي لا يطبطب عليها من نحب. متباينةٌ الليالي في مرور الوقت فيها. اشتباكات تختلف في مدى قوتها. نُصيب ونُصَاب. وما يكتب عليهم يكتب علينا. القوى تختلف. استعداداتنا متفوقة وضحايانا أقل. في ظل كل تلك القسوة يغدو تذكر وجهكِ مُنتهى النعيم الذي أرجو وتذكر لمسات أمي غيبوبة لا أوّد أن الاستفاقة منها. في آخر مكالمة بيننا كنتِ على وشك الولادة. الارسال في هذه البقعة من العالم ضيف جدًا. لم أتمكن من معرفة أنكِ وضعت سالمًا إلا بعد يومين. حين مسكت هاتفي وحادثتك كان يبكي، وحين سمعتِ صوتي كنتِ مرتبكة ولا تعرفين البدء من أي نقطةٍ عسيرة واجهتها في اليومين الماضيين. كنتِ هَاجرًا تكافحين وحدكِ دون ابراهيم. تمنيتُ لو كنت معكِ ولكن الهدف الأسمى أن يكون لسالم ورفاقه في المستقبل وطنٌ آمن. سجلتُ يوم ميلاده في مذاكراتي “يوم السلام”.
أموت؟ كان الظلام يغمرُ كل شيء أمامي. حاولتُ أن أنهض يدايّ كانتا تؤلمانني بشدة. ظننتُ أنني أحلم. رجلي اليسرى مقيدةٌ للأعلى ولا أستطيع النهوض. رفعتُ يدًا بصعوبة أريد تلمس وجهي. وقع الشاش في باطن يدي أرعبني. صرخت. لم يكن حلمًا. أطرافي مجروحة. ناديتُ أصحابي: حمد..عبدالله..بو غانم.. لم يجبني أحد. فجأة سمعتُ صوتًا ناعمًا: يقول لي: “أخي منصور اهدأ”. أدرك اصابتي. أستوعبها. يأتي الطبيب. يقول لي: “حمدًا لله على السلامة”. أقول له: “عينيّ. لا أرى”. يقول: “تمهمل”. أقول له مرة أخرى: “عينيّ. لا أرى”. يقول: “اصابتك بالغة لا تتحرك كثيرًا لا تقلق ستكون بخير”. أقول له: “لا يهم أن أكون بخير. أريد عينيّ”. يقول لي: “سأعود لك بعد قليل”. أصمت. وأغوص في نفسي. ماذا حدث لي. في الساعات التالية تذكرت. يا إلهي! كيف هم باقي الرفاق. أنادي على أسماء رفاق المعسكرات الأخرى علّ أحدًا يجيبني: أبو وضاح..هادي..حسين..عيد..هل أنتم بخير؟ آمل أن يرد علي أحدهم. سمعتُ بكاءً مكتومًا بجانبي. يصلني. أسأل: من أنت؟ لا يرد؟ أعيد. لا يرد. أعيد. أقول له: أنا منصور..منصور القطري. يردّ بحرقة: أبو وضاح مات يا منصور! كان عيد، الرجل المرهف صاحب الأغنيات الناعمة. شعرت بالنار تجتاحني. كنا في خط التماس. كان الوقت ليلاً. نراقب أنا والرفاق. كنتُ وعيد القناصين في أعلى الجبل. والبقية أسفله. ممددين وبجانبي قناصتي المحببة (ام 16) وعيني على العدسة أراقب بتركيز ورشاشي إلى جانبي تحسبًا لأي ظرف ومسدسي في محزمي. تسلل بعض المقاتلين. انطلقت الشارة. تحركت المدفعية. كان عددهم قليلاً ثم يزداد. نقنصهم أنا وعيد. بطلقات كثيرة. يسقطُ بعضهم وبعضهم ينجو. تنتهي الطلقات. نستلُ الرشاشات وأيدينا على الزناد. لا نتوقف. يسقطُ جندي منا في الأسفل، تندفع المدفعية. تزداد الطلقات. ترتفعُ وتيرةُ المعركة. النيران تشعلُ الليل. تستترُ النجوم من الدخان. صرخات هنا وهناك. يأمرنا القائد بالنزول. ندافع ونطلق. نعيد تلقيم الرشاشات ونصوّب ظهري إلى ظهر عيد. أسمع صوت هادي يستغيث. أركض إليه مصابًا ويحتاج اسعافات. لا أتمكن من تقدير وضعه، أطلب النجدة وأعطي احداثية مكانه عبر اللاسلكي. أسحبه وراء جبل يعصمه من وابل الطلقات العشوائية. عيد في الأمام. بعض الجنود ينضمون إليه. أصعد الجبل أطلق من الأعلى حيث الرؤية أوضح, يأمرني القائد أن أنزل: لا مجال لأقول له أن موقعي هنا أفضل. أنزلق من فوق الجبل. وانا أقول لهادي أنهم سيأتون لمساعدته. أثناء نزولي أرى بعض المتسللين الذي تجاوزوا عيد والبقية. أصوّب تجاههم. يلاحظهم أبو وضاح يسددُ من ورائهم ينتبهون له ويطلقون عليه. أنبه عيدًا. يزحف هادي من الخلف ليطلق من وهن. ينتبهون له. أندفع باتجاهه لأحميه. أتذكرُ أبناءه العشر وزوجته اليتيمة. يرن النشيدُ الوطني في أذني:”جوارحٌ يوم الفداء”. أصل إليه أسحبه للداخل. المسلحون يقتربون. أتركه. أجري قليلاً. أراهم. أنخفض. أصوّب تجاههم يسقطُ ثلاثة. أرى اثنين يقبلان عليّ. أصوب من جديد. تنفدُ رصاصاتي، أعيد تلقيم رشاشي. يغتنم أحدهم اللحظة ويصوب باتجاهي. تصيبني طلقة في رجلي. أتراجع. أخرى في كتفي. أقع. أشعرُ بدمي يتفجرُ حارًا كبركان. أقوم. أتألم. أميل. أتكئُ على الرشاش. أخرج المسدس. يؤخرهما عيد بطلقات عشوائية. يتعثران. يسقطُ أحدهما قتيلاً. يركض الآخر يقذف شيئًا. تنفجر الأشياء حولي. صارت السماء فوقي بلون الشفق. الشرر يهاجمني. أسمع صوت عيد يناديني من بعيد: منصور!
فزعًا أستقظ ليلاً. تهدئين من روعي يا علياء. عين عليّ وعين على (سالم). عبثًا أحاول التأقلم مع ظلام عالمي الذي يقول الطبيب أنه وضعٌ مؤقت، وعبثًا أحاول تصديقه. أجاهدُ نفسي على التعوّد. في كل مرةٍ يقول الطبيب: “سنفكُ الضمادات عن عينيك الموعد القادم” أنهزم. تخيلتُ كل التضحيات التي من الممكن أن يقدمها قناصٌ فداءً لوطنه. تخيلتُ حتى موتي؛ هبوط الطائرة. وجه أبي وهو يشبه القلق. شكل دموعه المحتقنةِ في عينيهِ وهو ينتظرُ خروجي إما من البوابة العلوية للطائرة حيّا. أو من البوابة السفيلة شهيدًا في صندوق خشبي. تخيلتُ أمي وهي تحاول الإتصال بأمهات أصدقائي الذي تعرفهم وعلياء تحاول مع زوجات بعض الرفاق لمعرفة أي شيء يطمئنها. لا أحد يقول شيئًا عن العائدين من الحرب. كل خبرٍ أشبهُ بسر كبير يسّرُ به على هيئة أسى. الأسرار قيد. نظلُ محكومين إليها وليس كل قيدٌ يقال له: ” أعطني حريتي”. أساير الجميع. أحاول أن أشد من عزم نفسي. أذهب إلى حفل تكريم العائدين من الحرب. شهداء يمثلهم أحباؤهم ومقاتلين أنهكتهم الحرب. اختتمتُ كلمتي بقولي: ” إني أخجل من كل الدموع التي تتساقط لأجل أوجاعي. مضطربٌ لأن لعيني ظلام إلى أجل غير مسمّى. فتحملوني، مؤمنٌ أنا أن هذا هو العطاء الحقيقي. أن تعطي ما تحب لا ما لا تريد الاحتفاظ به. حب الوطن لا يحتاج بصرًا. إنه بصيرةٌ لا يدركها الجبناء”.
____________________________________________
*حذاء ثقيل يلبسه العسكر.
*قصيدة من الفلكور الجازاني