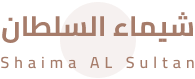حربٌ خلف أبواب البيت
وصلني بالأمس سؤال عبر صفحتي في (الآسك) عن حدثٍ غيّر حياتي. فكرتُ مليًّا ولم أجد حدثًا واحدًا غيّر حياتي إلا أمرًا واحدًا وهو أول قراءة لي في الفلسفة. أخذتني الفلسفة إلى أعماق لم أصلها من قبل وأرتني آفاقًا لم أكن أدرك أنها موجودة. الآن أدرك بعد كل الأفق الذي تكشّف أمامي صغر العالم الذي كنتُ أعيشه ومحدوديته وصغر إمكاناته. ولحسن حظي أن والدي كان إلى جانبي دومًا، يجيب على تساؤلاتي مهما بلغت حدّتها أحيانًا..مهما بدّت غير أليفة ومهما كانت الإجابات قاسيّة حين أربطها بالواقع.
تعلمتُ مع الوقت ألا أسمع إلا صوت العقل فيما يتعلق بالمعلومات التي أتلقاها يوميًا. وألا أكترث بالناقل أو المنقول عنه بقدر ما يهمني فحوى ما أسمع وفحوى ما يدور. تعلمتُ أن لا أثق إلا بما يمر عبر عقلي ولو كان قائله شيخًا يشهق الناس بإسمه أو عالمًا لا يختلف طلبته عليه. تعلمتُ أن سُعار العاطفة اتجاه القضايا التي تمسُ الوطن العربي ليس إلا هباء. وأننا رغم كل ادعاءاتنا المعرفية “الشكلية” لم نتعلم إلا “الصراخ” في وجهِ بعضنا البعض وتحويل غضبنا على أنفسنا واستخدام أقوال أي حد غيرنا لغسل عار عقولنا.
إن ما نراه اليوم أمامنا من الكم الضخم من الشتائم ومن الكم الهائل من تبادل الاتهامات بين الأحزاب أو الطوائف المختلفة لا يدل إلا على عدم أماننا اتجاه المستقبل لأننا ما زلنا عالقين في آفاتِ الماضي. وأننا رغم القيّم التي حاولنا التجمّل بها في وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الإجتماعي توصلنا إلى “خوائنا” وأننا لسنا سوى أبواق ينفخ فيها رجال الدين وينفخُ فيها الساسة وينفخ فيها كل من شاء دون أن ندرك صوتنا الحقيقي. دون أن يكون للوعيّ منَا محل ودون أن يكون للعقل علينا سُلطة.
حين نتحدث عن القيّم التي تقود المجتمعات كالتعايش والسلم والعدل والمساواة علينا أن ندرك أنها لا تقوم بمهرجانات أو حفلات خيرية أو حملاتٍ لجمع التبرعات أو شعارات نرددها أو رموزًا نفعّلها بين الحين والآخر. بل على هذه القيم أن تتجاوز مشاعرنا إلى عقولنا وتترجم على شكل سياسات وأنظمة حقيقية وواعية وصلبة حتى لا يتم التلاعب بها وتطويعها من قبل أي أحد.
وعلى كل شخص منا أن يسأل نفسه أولاً قبل أن يرسل “برودكاستًا” طائفيًا، أو قبل أن يرد ليشتم فلانًا أو قبل أن “يرتوت” لشيخه المفضل أن يفكر مليًّا في أثر “كبسة الزِر” التي قد تجعله سفيها لا يدرك أو ساخطًا لا يدري ما الذي يفعله. إنها لحظة واحدة تحددُ وعيّك اتجاه الدُنيا فلا تتعجل. العجلة تفسدُ كل شيء. اندفاعنا الشعوري اتجاه ما يمتُ لما نعتقد أنه “دفاع عن الحق” قد يتحول إلى أداة تشويه لا غير. قد تكون نيتك سلمية أحيانًا ولكن النوايا وحدها لا تكفي لتبنيَ محيطًا تأمن فيه على أبنائك في المستقبل. علينا أن نكف عقولنا عن التوافه التي تنحدرُ بإنسانيتنا. علينا أن لا نهدر المزيد من كرامتنا التي حبانا الله إياه وضيعناها نحن في الكثير من المهاتراتِ العنصرية الظالمة المقيتةِ التي تنبذُ الآخر ولا تقربنا من أنفسنا حتى أشعلنا حروبًا خلف أبواب البيت الواحد!
يقول الدكتور جاسم سلطان في كتابه: (التراث واشكالياته الكُبرى) عن معوقات التطور الحضاري:
“الإيمان قضية تزيد حساسية النفس الواعية بمتطلبات العمل وتلك مفارقة لا يدركها القوم حتى بعد أن تكشفت حقائق في عصرنا الحاضر. فالخطاب الديني ما زال يبشر بالحل الإيماني عازلاً له عن سياق العمل المتعلق. بينما الحل يكمن في العمل على بصيرة وليس مجرد العمل العاطفي، وهذه البصيرة تشمل الوعي بالدين والوعي بالدنيا التي يعمل فيها الدين وهو التقاء العقل الذكي بالقلب النقي بالواقع الحي في تفاعل مثمر”