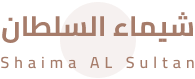“الحُب” أم “الكُره”؟!
الطريقُ الطويل أشبهُ بماسحٍ ضوئي، تتجلى فيه الأفكار وتتضحُ فيه الرُؤى. هو الطريقُ الأقربُ للحوار مع النفس وكشفِ ما يدور في خلدها. تراودنا الأسئلة، وخير الأسئلة تلك التي تغوصُ في أعماقنا لتجتث الإجابة منها، فتُلهمنا لفعل الصواب.
سؤال بسيطٌ يطرقُ أبوابي هذهِ الأيام وهو: هل أساسُ علاقتنا مع الآخرين حولنا “الحُب” أم “الكُره”؟! سؤالٌ تثيرهُ رداتُ الفعلِ المُنحازة، وتختصمُ لديهِ العقول والأهواء. وهنا لن أتخذ منهجاً علمياً ولا فلسفياً لمحاولة الإجابة على هذا السؤال، ولكني سأفكرُ بصوتٍ عالٍ علهُ يُسمعُ فيُفهم، ويكونُ بعيداً عن التفاسير الضنّية التي لا تصيبُ “بطن الشاعر” غالباً..!
إن قُلنا بأن الأصلَ هو “الحب”، فعلينَا أولاً وقبلَ أي شيء افتراضُ حسنِ النية في الآخر وذلك في طريقةِ تعاملنا معهُ في جميعِ الأوقات وأهمها وقت السَخط إن أساء الفعل أو خانهُ التعبير. إن ردة الفعل انعكاسٌ لدرجةِ حسنِ ظننا في الآخرين. وثانياً: أن نقولَ بالتسامحِ مع وقوعِ الضرر مع تقدير درجتهِ وتقديرِ العقاب الصحي الذي لا يوّلد ردة فعلٍ عكسية. علينا أن نفكرَ كيف نُحب قبل أن نفكر كيف نُعاقب. إن الحبُ هو المُربي الذي يقوّم العواطفَ ويهديهَا إلى خيرِ الفعل. وقليلٌ من الحنانِ كفيل بخلقِ جنين جديدٍ يتعلمُ أبجديةَ الحياةِ على يدِ أمٍ رؤوم. إن بذرةِ الحبِ تولدُ التسامح، والتسامحُ يقودُ إلى صلاحِ الفردِ والمُجتمع.
وإن قلنا بأن الأصل هو “الكُره” فإننا نكونُ خلقنا من العالمِ مَقبرةَ كبيرةً تأوي الأحياءَ منا والأموات. فما طائلُ الحياةِ إن حملَ القلبُ ضغينة أو لامسهُ الجفاء؟! يستسهلُ البعضُ “الكُره” ويجعلُ منهُ “برستيجاً” ثمَ يصفُ نفسهُ بـ “المُعتدل” أو “الممتثل لأمرِ الله”. إن رسالةِ الإيمانِ في الدُنيا وجدت ليكونَ الكونُ أكثر رحابة، وموطناً يعيشُ فيهِ الكلُ تحتَ سقفٍ واحدٍ تظلّهم مظلةُ “الأخلاقِ” التي جاءَ ليتممهَا سيدُ البشرية عليه أفضلُ الصلاةِ والسلام. إن في قولهِ صلى الله عليه وسلم: (اذهبوا فأنتم الطلقاءُ) رسالةٌ كونية عظيمةٌ لمن أساء وزَل. إنها درسٌ في تقليلِ مساحاتِ الخلاف وعدمِ سكبِ الزيتِ على النيرانٍ المُتقدة. إن جراحَ الجسدِ قد تزول وتندمل، أما جراحُ النفسِ فإنهَا تأخذُ أمداً طويلاً إن لم يطبطب عليهَا الحبُ والحنان والتسامحُ.
إن القطيعة بينَ العقلِ والقلبِ تنبتُ التطرّف والتعصّب ولا عاقل يريدُ أن يقعَ في هذا المطبِ الشائك الذي لا يلقي بصاحبهِ إلا إلى التهلكة. ليسَ من الصعبِ أن تأخذ موقفاً حيادياً في كثير من الأمور، قبلَ أن تطلقَ حُكماً وتشتمَ إنساناً يتنفسُ الهواءَ الذي تتنفسه ويقولُ: يالله! كما تقولها أنت، توقف، توقف وفكر في موقفِ الطرفين (المؤيد والمعارض)، ضع نفسك مكانَ “المُخطئ”، ما هو أول ما سيخطرُ على بالك؟! ثمَ فكر بأن من أخطئَ لهُ ربٌّ يحاسبهُ وواجبنَا قبلَ العقابِ التَناصح. فكر في أهلك إذا زلّ أحدهم ولا تأخذكَ العزّة بإيمانك فالمالُ والبنونُ نبضُ الحياة. تريث ثم قرر أي طريقٍ ستسلك؟ نهجَ العقل المغمور برحيقِ القلب، أم القلبَ المنزوعَ من نعيمِ العقل؟!
إن من يقفُ على ربوةٍ عاليةٍ لا بدَ وأن ينتظرَ للعالمِ حوله بعينِ الكِبر. إن النفس لتجدُ ضالتَها في وجوهِ الناس المُبتسمة، التي تتعاملُ مع الغلظةِ باللين ومع الزلل بالغفران، وتتجَبّرُ حينَ تُخرسُ أسئلتها وتكتمُ أنفاسُ الشكِ فيها فلا تجدُ مرسىً آمناً ولا ممرَ عبور!
لكلِ طريقٍ آخِر، وآخرُ هذا الحديثِ دعوةٌ صغيرةٌ للتسامح، لفتحِ القلوب على مِصراعيهَا والتغاضي عن الزلاتِ والمُنغصاتِ اليوميةِ للحياة التي تُغلقُ أبواب الفرح. تذكروا دوماً: أننا نتسامحُ اليوم ليَكون المُستقبلُ أكثر رَحابةً وأمناً.